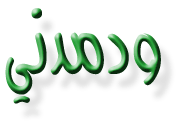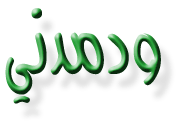|
ما إن ولجت ساره من باب الحوش حتى ألقت
بحقيبة كتبها في أقرب سرير وأسرعت الى المطبخ، وتناولت خبزة وفتحت قدر
الطهي- الذي ما زال على النار- وأدخلت طرف الخبزة فيه تغمسها في محتوياته.
- يا بت انت مالك بقيتي اول ما تجي من المدرسة تكابسي حلة الملاح كأنك ما
أكلتي من الصباح؟ ما قاعدة تشيلي سندويتشيك معاك؟
- قاعده أشيلو يا أمي.
- ما قاعد يكفيك؟
- .....
- مالك ما بتردي؟
- بصراحة يا يمه ما قاعد يكفيني.
- عيشه كاملة ما قاعده تكفيك؟ أصلو بطنك دي مسكونه؟
- .....
- ما تردي!
كانت لحظتها تنفخ في الإدام الساخن في طرف الخبزة ليبرد حتى تستطيع
التهامها، فلم تكن لتصبر حتى يبرد بفعل الهواء، وقضمت منه قضمة قبل أن ترد
على أمها:
- لا يا أمي، ما مسكونه ولا حاجه، بس..
- بس شنو؟
- بس كل يوم قاعده أفطّر معاي بنتين ما عندهن فطور.
عندما سمعت هذا الحوار في منزل شقيقتي أكبرت في إبنتها سارة تطبيق التكافل
رغم أنها لم تتلق فيه دروساً في المدرسة، وتصرفها النبيل هذا ليس بغريب على
مجتمع عرف التكافل ممارسة بالفطرة، وسارة لم تخبر أمها قبل ذلك رغم أن
نصيبها في فطورها تقلص الى الثلث؛ فهي تكتفي بثلث وجبتها لتساهم بالثلثين
في إبعاد شبح الجوع- ولو جزئياً- عن زميلتين قهرت الظروف أسرتيهما فأضُطرتا
أن ترسلاهما الى المدرسة بدون فطور أو بدون مصاريف الفطور.
ولم أكن أعلم قبل اليوم أن مثل هاتين التلميذتين كثير هذه الأيام.. أعلم
أنه ضاقت على الناس سبل الحياة، ولا أدري من كان السبب، هل هي الحكومات
الوطنية المتعاقبة، أم أولئك الذين حاربوا بلادنا وحاصروها وقاطعوها وألبوا
عليها حتى الأشقاء والجيران.. ولكني لم أتوقع أن تكون الأمور قد وصلت لهذا
الحد، لكن بالفعل وصل الحال الى أن من تدرس الآن- وينقصها الفطور فقط- فهي
في نعمة، وخير من إخوانها الذكور الذين أخرجهم أهلوهم من المدارس ليساعدوهم
في توفير القوت الضروري، الذي اختُزِل الى وجبة واحدة في اليوم غالباً
تتكون من دكوة بالطماطم في الشتاء- لرخص سعر الطماطم- أو طحنية مذابة في
الماء أو سخينة أو شئ من هذا القبيل في غير الشتاء، مضحين- وقلوبهم دامية -
بمستقبل التلميذ الدراسي مقابل تلك الوجبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع،
تجتمع حولها الأسرة في آخر اليوم وتكمل غداءها/ عشاءها بالماء.
ويمر من أمامي شريط للبلاد التي أعيش فيها في مغتربي، وأرى حاويات النفايات
تمتلئ باللحم والأرز والدجاج وأطايب الطعام، بل وبالتفاح والبرتقال وفاكهة
من الشرق وأخرى من الغرب، حيث تجتمع على تلك الولائم اليومية القطط المدللة
التي إن رأت فأراً جلست باسترخاء تتفرج عليه- كأنما تراه على شاشة التلفاز-
وهو يتبختر أمامها في طمأنينة، بل ويشاركها ما لذ وطاب من المندي والمظبي
والسليق والحنيذ، ويبدو أن طبيعتها التي جُبِلت عليها قد تغيرت، فلم تعد
تشتهي طعام بني جنسها المفضل لهم منذ القدم، فقد توفر لها المشوي والمحمر
والمسلوق، فلماذا تستبدله بلحم فئراني نيئ!
أتُحِس ساره الطفلة الصغيرة بمعاناة الغير، وأنا في غفلة من كل ذلك؟ أتكون
قد أنستني سنين الغربة المترفة مرارات الماضي وأحزان الحاضر، وأعمتني فلم
أعد أرى تلك المعاناة، ؟ لا.. لا يمكن أن أكون في غفلة، ولن أقف متفرجاً
على تلك المعاناة.
***
دلفت عبر المدخل المخلوعة بوابته لمدرسة السكة حديد الإبتدائية بود مدني
قاصداً النيمة العتيقة حيث تجلس تحتها (ست الفطور) التي رأيتها تعمل منهمكة
في تجهيز السندوتشات للتلاميذ، ويبدو أن وقت خروج التلاميذ في فسحة الفطور
قد أزف لذلك هي تسابق الزمن لإعداد أكبر عدد من الساندويتشات قبل هجومهم
لشراء ما لديها، لذا لم تتنبه لوصولي ووقوفي أمامها قبل أن ألقي عليها
السلام، ولم ترفع بصرها عما في يدها من الخبز والطعمية عندما ردت السلام،
إلا بعد هنيهة وبطريقة سريعة ومباغتة- وكأنها استوعبت لحظتها فقط أن صوتي
ليس مألوفاً لها- وارتبكت عندما رأتني (يبدو أنها ظنتني موظفاً في المجلس
المحلي جئت لأرمي برأسمالها- الحلة والصحون والخبز والفول والسلطة- في
برميل القمامة)، ولكن عندما لم تجد وجهي مكفهراً ولا نبرتي حادة ومهددة؛
هدأت نفسها، وتحولت تعابير وجهها الى وضع التساؤل عما جاء بي، دون أن تترجم
ذلك الى كلمات.
سألتها عما إذا كان هناك تلاميذ لا يجدون ما يفطرون به، فأجابت بالإيجاب،
فمددت لها يدي بورقتين نقديتين من فئة العشرة آلاف جنيه، فلم تمد يدها
لاستلامهما، وبدأ على وجهها الحذر والتردد، بل وشئ من التوجس والريبة،
فأدركت على الفور ما تفكر فيه.
- ديل قروش فطور للأولاد الماعندهم حق فطور
- لكن ديل كتار
- فطري بيهم الليلة وبكره لغاية ما يكملوا
- كان كدي معليش
توجسها وريبتها التي ظهرت على وجهها في البداية نبهتني إلى أنها في مثل سني
تقريباً، أي لم تكن (حبوبة ستنا) التي كانت تبيعنا الفطور منذ ثلاثين عاماً
في هذا المكان نفسه، تحت هذه النيمة بالذات..
حبوبة ستنا..
وفي ثوان كنت على متن (آلة الزمان) في رحلة الى أواخر ستينات القرن
العشرين.. وأنا أقف على مقربة من حبوبة ستنا والتلاميذ يتدافعون ويتزاحمون
حولها لشراء فطورهم منها، ولما انفض الجمع من حولها وبدأت تعد قروشها، كانت
حلة الفول وصحن سلطة الأسود وكورية الشطة وكذلك قفة الخبز، كلها خاوية.. لم
أزاحم مع التلاميذ لأحصل على ساندوتش، لأنني ببساطة لا أملك قرش الفطور،
كنت أطمع فقط في قطعة خبز صغيرة تغمسها حبوبة ستنا في (موية الفول) وتعطيني
إياها لأسد بها رمقي، لكن لم يبق شئ من فول ولا (موية فول).
وجلس التلاميذ تحت الشجر وفي ظل الفصل يأكلون طعامهم، ذهبت للمزيره لأشرب
الماء ظناً مني أنه يمكن أن يُسكِت جوعي، لكنني لم أستطع أن أتجرع شيئاً
منه، فقد جعله الجوع يؤلمني في فم المعدة، فرجعت لأجلس تحت ظل الشجرة،
تصارع مصاريني نفسها في معركة خاسرة أحس نتائجها في لعابي الذي يسيل بلا
لقمة توقفه..
راقبت عمر وهو يقضم من ساندوتش ضخم لا يتناسب وسنه الصغيرة، ولكن يبدو أن
أسرته الثرية تحشو له الساندوتش بما لذ وطاب حتى تكاد الخبزة تتفجر مما في
جوفها.. ويسيل لعابي أكثر، وأحس بالجوع أكثر فأكثر لدرجة الغثيان.
ويضع عمر ما تبقى من ساندوتشه على الأرض ويذهب، لقد شبع وترك أكثر من
نصفه.. لم يعد لي شئ أفكر فيه غير بقية الساندوتش الذي تركه عمر.. لا
أستطيع أن أقاوم تلك الرغبة العارمة في الأكل..
***
لماذا لم يرجع أبي منذ أن فارقنا قبل شهور طويلة؟ لماذا لم يرسل لأمي
المصاريف لتعطيني منها (حق الفطور)، أو لتشتري منها الدقيق (الفينو) لتصنع
لي منه (قراصة الطوه) وتضعها في (الكورية الصغيرة) وتربطها بالمنديل- كما
كانت تفعل- لأحملها معي الى المدرسة وأفطر بها؟ لماذا لا يرجع لنا لنشتري
اللحم والخضار؟ لقد مللنا أكل السخينة وبليلة الذرة.. كل الناس عندهم قروش
الفطور أو يحملون معهم فطورهم من البيت إلا أنا! حتى التميرات- التي كانت
تعطيني إياها جدتي في الصباح وأنا ذاهب للمدرسة وتقول إنها تقيني زمهرير
الشتاء-لم أعد أحصل عليها لتوقف إرسال البلح لنا من أهلنا بالشمالية لأنه
ما عاد لنا أهل هناك، فقد استقروا كلهم معنا في المدن.
***
قمت من مكاني ومشيت في الاتجاه المعاكس لموقع الساندوتش، ثم بعد التفافة
كاملة مراوغة مشيت باتجاهه وأنا أنظر بطرف خفي لبقية التلاميذ حتى لا
يلاحظوا ما أنا مقبل على فعله، ولما كان كل واحد مشغول بما في يده من طعام،
جلست بجانب ما بقي من ساندوتش عمر، ومددت يدي خلسة إليه فالتقطته، وقربته
الى فمي، كانت رائحته لذيذة، ونظرت فيه فإذا النمل قد سبقني إليه.. لا لن
أسمح للنمل بسلبي هذا الطعام الشهي، فنفضت النمل عنه وقضمت منه قضمة، وبدأت
ألوكها..
لم أستطع مضغها؛ فقد جف لعابي تماماً، وحاولت أن أبتلعها كما هي، لكن حلقي
كان قد انسد.. وتورم.. لقد خنقتني عبرة حرى.. وتدافع جوفي بأكمله الى حلقي
يريد أن يخرج عبره، لكن لم يكن في معدتي شئ يخرج، لذا أوجعتني وجعاً شديداً
إذ تكاد تنخلع من مكانها.. ونزلت دمعتان ساخنتان على خداي، وحاولت أن ألفظ
اللقمة من فمي فلم استطع، لقد تيبس فمي تماماً، وتحجرت عضلات فكي ووجهي..
فلم يكن بدٌ من إخراجها بيدي، وطرحتها وبقية الساندوتش على الأرض، وتلاحقت
دموعي التي لم أستطع حبسها، لكني جاهدت لأكتم نشيجي..
وبعد هنيهة سمعت نشيجاً حسبت أنه غالبني فغلبني ثم أفلت مني، لكني تنبهت
إلى أنه ليس صادراً مني، بل من شخص آخر، مسحت دموعي المنهمرة لأتبين الأمر،
فإذا بـ (ست الفطور) هي التي يصدر منها النشيج، مالها حبوبة ستنا تبكي؟ لا،
لم تكن هي حبوبة ستنا، بل كانت هي (ست الفطور) الأخرى، الشابة، لقد عادت بي
آلة الزمان من ستينات القرن العشرين الى غرة الألفية الثالثة.. وما زالت
يدي ممدودة إليها بالورقتين النقديتين.
- تبكي مالك يا ود عمي؟ بكيتني معاك
- أنا؟ ما كنت ببكي، الكان بيبكي ولد صغير عمره 8 سنوات
- وينو؟ مافي ولد هنا، مافي غيرك هنا
- قصدي أنا ذاتي بكاني الولد ده
- وينو؟ انا ما شايفه ولد هنا
- لأنو كبر وبقى فوق الأربعين
- ما فاهمة اي حاجة
- هاك امسكي ديل
وأخرجت بقية رزمة الأوراق النقدية من جيببي- بربطتها وعليها ورقة البنك-
ومددتها لها، فرجعت الى الوراء قليلاً كأنما خافت من الرزمة..
- أمسكي يا بت عمي
- ديل شنو؟
- قروش
- عارفاهن قروش، لكن لشنو؟
- اي شافع ما جاب فطور من بيتهم، ولا عندو حق فطور تديه فطور وتخصمي من
القروش دي
- لكن دي قروشاً كتيره
- يا ريتا كان تكفي لغاية ما أجيك تاني في الإجازة الجايه، أو أرسل ليك مع
زول جاي البلد
- طيب حقو تسلمها لمدير المدرسة، دي قروش كتيره وخايفه تروح مني واللا
يسرقوهن
- أديها انتي للمدير، وكلميه يوصي المدرسين انو اي شافع ما عندو فطور يجيك
طوالي
- لكن يا ود عمي..
***
وغادرت المدرسة، ومشيت في طريق البيت، عيوني محمرة ومنتفخة، تتقاذفني مشاعر
شتى، خليط من الحزن والأسى وراحة الضمير، سرت صامتاً، مطرقاً إلى الأرض
طوال الوقت، ووصلت إلى منزلنا، ومددت يدي لأفتح باب الحوش، إلا أن صوت طفل
صغير أوقفني:
- داير منو يا عمو؟
- داير....
وتبينت في وجه الطفل الذي كان يلعب بالطين أمام باب الحوش.. إنه لم يكن قمر
الدولة- أخي الصغير- بل طفل آخر.. فأدركت أن قدماي قادتني لبيتنا القديم..
- إزيك يا ولد
- أهلا يا عمو
- ده بيتكم؟
- آي
ولم أجد ما أقوله.. وبعد هنيهة قلت له:
- ده كان بيتنا زمان
- .....
ويبدو أن الطفل لم يستوعب ما قلته، فحدّق في وجهي ثم عاد يلعب بالطين..
لقد قادتني قدماي دون وعي مني - وفي تأرجح بين الماضي والحاضر- الى بقعة
مولدي ومرتع صباي، وكأنني راجع من المدرسة أحمل مخلاية كتبي على ظهري..
هأنذا قد سلكت نفس الطريق الذي كنت أسلكه في الماضي من المدرسة إلى البيت،
مشحونة مشاعري بذكريات ذلك الماضي البعيد، والذي طالما حلمت- وأنا أزرعه
جيئة وذهاباً من المدرسة- بمستقبلٍ مشرقٍ يزيح عني شبح الجوع، وأكتسي فيه
ملابس جميلة كالتي أراها عند الأطفال يوم العيد، وبدراجة تريح أرجلي
الصغيرة وأقدامي، وأحمل عليها كتبي ودفاتري التي تثقل كاهلي الصغير.. ويا
حبذا لو كانت هذه الدراجة (عجلة سرعة).
وقفلت راجعاً الى حيث كنت قد أوقفت سيارتي –عند مدخل مدرسة السكة حديد
الابتدائية- ويبدو أنني في خضم المشاعر والأحاسيس المتباينة، والسفر
والعودة في الماضي والحاضر، نسيت أن أهلي قد رحلوا من هذا البيت ومن هذا
الحي منذ عقد من الزمان.. ونسيت أنني قد تخرجت من هذه المدرسة قبل ثلاثة
عقود.. ونسيت أنني جئتها اليوم بسيارة..
فتحت باب السيارة وركبت خلف عجلة القيادة، وأدرت مفتاح التشغيل.
- فضلاً أربط الحزام
ذكّرني الكمبيوتر الناطق في سيارتي بربط الحزام..
***
تالله ما أعذب أحلام الطفولة: ساندوتش فول، و(عجلة سرعة).
|