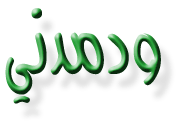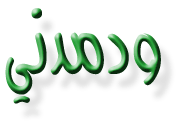|
إن فكرة كتابة هذه الرواية- المذكرات -
القادمة قريباً بإذن الله والتي شارفت فصولها علي الإنتهاء بكل ماتحمله من
أحداث وقصص وشخصيات حقيقية كانت تسطع في سماء مدينة الأحلام .. ودمدني
الجميلة ، كانت فكرتها محض صدفة بحتة ليس إلا، فقد سافرت عائلتي إلي بركات
ضاحية ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة بالسودان في بداية صيف الخليج بالدوحة ..
وتحديداً في ( يونيو2001م) حيث كانت المدارس بدولة قطر – مقر عملي سابقاً -
قد أكملت عامها الدراسي وبدأت صالات مطار الدوحة الدولي تزدحم بالمسافرين
مثل ما يحدث في كل صيف في معظم دول الخليج، أجناس مختلفة من البشر ، أطفال
ونساء ورجال ، حقائب وأكياس وكراتين ، ومسجلات كبيرة في الأيادي وعروض
أزياء من بنات حواء ، والحُلي تجِّمل أياديهن المخضبة بالحنّـاء فتضفي علي
ظاهر اليدين مسحات جمال من أشكال النقوش المتعددة ، وهو مايميز حواء
السودانية عن غيرها من نساء الدنيا ، والكل يرغب في الوصول إلي دياره
الأولي بعد عام كامل من الإغتراب عن العشيرة و عن الذكريات الطيبة المكتنزة
بجبال من الدفء ، مما يعود بنا شخصياً إلي تراكم من الذكريات الرطبة عن
مدينة الأحلام.. ودمدني.
ومع بداية هطول أمطار خريف الغضب ذاك بالسودان كان وصول عائلتي إلي مدينة
الأحلام .. ودمدني الجميلة ، تقودهم السيدة ( أم عمرو) رفيقتي في كل
إهتماماتي.. فهي الناقدة الأولي لكل ما نكتبه للناس .. سافرت وكان في
معيتها ثلاثة زهرات.. زهراتي أنا.. وأيضاً زهراتها هي . وتركوا معي بالدوحة
وحيدي وفارسي المغوار( عمرو) لأسابيع معدودة .. لكنه سرعان ما يمم شطر
الخرطوم بعد شهر من سفر والدته .. ترك دراسة علوم الكمبيوتر بالدوحة بعد أن
أنهي فصلاً دراسياً كاملاً في الدراسة بالكلية ، لكنه لم يجد نفسه في مجتمع
الإغتراب الأكاديمي ، فقد كان يشكو من عدم حيوية الحياة الطلابية بالخليج
مقارنة بمثيلتها في السودان، خاصة وهو قد نال تعليمه كله بالسودان حتي
الشهادة الثانوية بودمدني، عاد إلي الخرطوم ليلتحق بكلية الهندسة بجامعة
السودان ، فقد كانت هي أمنيته منذ البداية ، فالرجل يريد أن يصبح مهندساً
في الكهرباء ، لعله بذلك يحلم بأن يحافظ عليها من الإنقطاع المبرمج ، ولكنه
تركها ليلتحق بكلية شبكات الحاسوب بجامعة الخرطوم .. ولعله الآن يعبر كل
الشوارع بحرية تامة دون الإحساس بهاجس تفتيش الإقامات أورخصة القيادة ..
فالبلاد بطولها وعرضها ظلت مفتوحة وستظل كذلك إلي ماشاء الله.
ولكن.. ظلت معي بالدوحة حينذاك أكبرهنّ .. أعقلهنّ .. وأكثرهن إلتصاقاً بي
، بقيت معي زهرتي الكبري ، والتي عندما رزقنا الله تعالي بها ، كنت أعمل
بالمملكة في جدة وقتذاك خلال الفترة ( 1975---1987م) ، جدة التي كان الهدوء
يظللها ولم تكن حينذاك قد نالت حظها من الإتساع المعماري بعد ، ثم أطل بقوة
هذا التمدد الجميل الرائع لمدينة جدة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، و
قد كنت محظوظاً إذ أنني قد عاصرتُ كل مراحل نهضة عمران مدينة جدة ومراكزها
التجارية وجسورها وطرقها السريعة وبعض معالم الكورنيش الجميل والإنتقال من
طريق مكة القديم الذي كان يشق ضاحية بحرة إلي نصفين إلي الطريق الحالي،
وحينذاك كنت أصنع أولي قصائدي لها .. لزهرتي الأولي عندما شرفتني بقدومها
إلي الدنيا في بداية مارس 1979م . علماً بأن قصائدي كلها ظللتُ أكتبها
لنفسي، لا للقراء ، ونادراً مايتم نشرها ، لأنني أهوي المقال وأجد نفسي فيه
أكثر ، وفي المقال أهوي المطول منه ولا أجيد كتابة الأعمدة القصيرة المدي ،
بل ظللتُ أندهش وأعجب كيف بلغ كاتبو الأعمدة هذه الموهبة التي يستطيعون
بواسطتها ضغط كل مايريدون في عمود صغير، لكنني شخصياً لا أستطيع ذلك ،
حاولت كثيراً ففشلت ، وحينما أكتب لصحيفة الشرق القطرية عمودي الإسبوعي
بصفحة السودان فإنني أتعب جداً من التشطيب والتعديل ، ولكن لا مفر ، إنهم
يطلبون عموداً فقط لا يتجاوز ورقة واحدة علي الكمبيوتر .أما لصحف السودان
.. تستهويني الكتابات التحليلية الطويلة بها والتي تحتوي علي التفاصيل
الصغيرة رغم أن الزمان قد أصبح سريعاً في إيقاعاته ، وربما أنني أُريد في
هذا التطويل أن أقول كل كلامي للصحف السودانية حتي الإلكترونية منها والتي
أتعامل معها – لوجه الله تعالي- قبل أن أغادرهذه الدنيا ، ذلك.. لأن كلامي
الذي تكتنز به ذاكرتي هو( كلام كثير جداً) ولا أريد أن أرحل وأحمل معظمه
معي إلي الدار الآخرة التي هي خيرُُ وأبقي ، ولعل قراؤنا بالصحف السودانية
التي نساهم فيها من وقت لآخر يلاحظون أن كتاباتنا تكون دائماً طويلة المدي
، فكثيرون يريدون قراءة حديث الذكريات بكل تفاصيله الدقيقة في كافة أجناسه
الإبداعية . وللتدليل علي حب أهل السودان للقراءة بنهم شديد فإنني سأروي
هنا موقفاً محدداً . وهو أنني ذات مرة قد سافرت من الدوحة إلي القاهرة في
نهاية عام 2000م لأقوم بإستلام و شحن كتابي الأول من المطبعة بالقاهرة إلي
الدوحة وهو كتاب ( أهل الإبداع في بلادي ) الجزء الأول-الذي يحكي عن جوانب
مضيئة في الفن السوداني وفي الشعر الغنائي والوطني تحديداً ، وأحسب أنه
يحكي عن جمال إبداعات شعب السودان عبر تاريخه الحديث ، وبقية الأجزاء ستأتي
حتي الجزء الرابع لندخل فيها بعض الألوان المختلفة من الإبداع المتسع إذا
أمد الله في أعمارنا ووجدنا الناشر الجاد بالسودان ، وفي فندق مونتانا
بشارع شريف بالقاهرة كنت قد قابلت أستاذاً جامعياً من جامعة الخرطوم و كان
في طريقه إلي الولايات المتحدة لحضور سمنار محدد في مجال تخصصه فأهديت ذلك
الأستاذ الجيولوجي وهو ( د0عوض البيلي) نسخة من كتابي وقد كان الوقت مساءً
، ثم تقابلنا في صباح اليوم التالي في جلسة الإفطار بالفندق فأخبرني بأنه
قد تفاعل مع موضوعات الكتاب ، بل وقد وإزداد إنفعالاً حين قرأ ما كتبناه من
ضمن مواد الكتاب عن مسيرة فنان أفريقيا الأول محمد وردي ، وظل الرجل يقرأ
فيه حتي أكمله بالكامل في الرابعة صباحاً رغم كثرة صفحاته التي تتعدي
المائة وسبعين صفحة ، مما يؤكد علي قولنا بأن القراء من أهل السودان تجذبهم
مفاصل حياة كل الماضي المشرق في كل شيء لعله يعود لهم مرة أخري بكل ألقه
وإشراقه ذاك .. ولكن هيهات.. هيهات .
وعموماً نقول أن أهل السودان لا يملون القراءة ، فتجدهم ينهمون السطور
نهماً ، بل يلتهمونها إلتهاماً عجيباً، وليس لديهم تخصص محدد في الإطلاع ،
فهم يقرأون أي شيء يجدون أنه يخاطب خيالاتهم ويزيد من حصيلتهم المعرفية ،
فتصبح السطور مثل وجبة دسمة يتم إعدادها لهم خصيصاً داخل بطون الكتب وأوراق
الصحف . وهذا ماجعل السودانيين (ناصحين ومفتحين) وكل منهم قد أصبح بنكاً من
الثقافة المتعددة والمعلومات المكثفة يتحرك بها في هذا الكون الواسع رغم
تقاطعات مسيرتهم بالأزمنة الرديئة أحياناً وبكل إسقاطاتها التي يسجلها
التاريخ في ذاكرته التي لا يخفي عليها شيء ، فأهل السودان لم يجدوا راحة
البال في الدنيا مقارنة بحجم الثقافة والمسؤولية وكل صفات الخير التي
يمتازون بها إذا ما قورنوا بالعديد من الشعوب بالمنطقة وبخارجها ، ولعل (
حظهم هو هكذا) ، إذن عليهم بالصبر والصبر الجميل ، والله المستعان .
أعود مرة أخري لأقول عن زهرتي الأولي ( نهاد) بأنها هي التي جعلتني لا
أتمتع بإجازتي الصيفية المستحقة كباقي خلق الله في بلاد الإغتراب في صيف
2001م ، فإضطررت للبقاء معها بالدوحة و لم أسافر مع العائلة ، لا لشيء …
فقط لأن إبنتي هذه قد شـبت عن الطوق وأصبحت موظفة تديرمفاتيح الكمبيوتر
لتؤدي مهام شئون الموظفين في الشركة الكبيرة التي تعمل بها حالياً بالدوحة
، نعم أصبحت إدارية في شؤون الموظفين .. فأحسستُ وقتها بأن العمر قد سرقني
ولم أسرقه ، و لذلك فإنني لم أشـأ أن أسافر في ذلك الصيف لأن في الأمر
إخراجها من عملها الجديد الذي وجدت فيه نفسها ، وما أصعب حصول البنات
المقيمات بالخليج علي فرصة عمل بسهولة ، فإنتظرت معها لحين ميقات حصولها
علي إجازتها السنوية ، ولذلك فقد قمت بتأجيل إجازتي كي أحرسها ، أو بالأصح
كي تحرسني هي أيضاً ، علي أمل أن نسافر سوياً عند إستحقاقها لإجازة السفر
والذي لحسن حظنا يصادف عيد رمضان ، وما أجمل الأعياد في السودان ، بل ما
أجمل جلسات إفطار رمضان المشترك مع الجيران في بلادنا ، فنحن لازلنا مثل
غالب أهل السودان نفطر جماعات أمام بيوتنا ونفترش البروش أو مفارش
البلاستيك علي أحسن تقدير حيث لا يمتلك معظم أهل السودان السجاد الفاخر ،
وإن إمتلكه بعضهم فإن ميعاد فرشه هو في الأعياد والمناسبات الخاصة ، فنحن
لم نتعود بعد علي الإنكفاءة داخل الحيشان ساعة الإفطار في رمضان ، لأن
الإفطار مع غير الجماعة لا تستسيقه النفس ، و لذلك نفضل تناوله مع الجيران
في البرش أمام الحوش وليس بداخله ، هكذا نحن وهكذا كثيرون غيرنا في السودان
الماهل العريض، فقد تبدل آخرون في عاداتهم بعد أن ظنوا أن في الإنكفاءة
حضارة ، ولكن الأغلبية تحافظ علي هذا التراث الراقي الوليف ، والذي بلاشك
يعتبر هو التوجه الحضاري الحقيقي وليس المجازي.
أما فكرة إصدار هذه الذكريات – الرواية - القادمة قريباً بإذن الله وبكل
مكنوناتها من الذكريات الرطبة عن مدينتي وعُشقي المستديم ودمدني .. مدينة
الأحلام .. فقد كانت مناسبتها كالتالي :
ذات يوم وقد كان جو البيت عندي بالدوحة موحشاً كعادته بعد سفرعائلتي .. طاف
بخاطري فجأة طيفها.. لم يفارق خيالي مطلقاً ذلك الطيف .. مذ تركت الوطن
وأنا لا أزال خريجاً طري العود أعمل بالمملكة العربية السعودية وقتذاك في
منتصف السبعينيات من القرن الماضي ، وهنا أرجو ألا تذهبوا بعيداً ، لأنني
أقصد هنا طيف مدينتي .. مدينة الأحلام وليس طيفاً آخراً ، رغم إعترافي بأن
هنالك طيفُ آخر بالفعل في الخيال ، ولم لا يكون هنالك طيفان في الخيال..
عموماً كنت مهموماً وأنا أدير السيارة خارجاً ذات صباح مشرق إلي عملي ،
ودائماً ما أدخل علي إذاعة لندن لسماع نشرة الصباح من راديو السيارة أثناء
(تسخينها) فالنشرة تأتي علي رأس كل ساعة ، لكنني في ذلك اليوم تحديداً قد
صرفت النظر عن سماع الأخبار في (البي بي سي ) فقد آلمني رحيل المذيع
المتفرد العريق ماجد سرحان نجم إذاعتها المتلأليء في لندن ، كنت أحب صوت
الرجل وأحب مداخلاته وخفة دمه من وقت لآخر في المذياع ( يرحمه الله) ، كما
أنني قد مللت تكرار أخبار تفجيرات برجي مركز التجارة في نيويورك وأنباء
الضربات الموجعة علي طالبان في بلاد الأفغان ، لذلك فقد أدرت كاسيتاً كان
مركوناً بمسجل العربة و لم أكن أدري ماذا بالشريط من غناء يريحني، ولمَن
مِن أهل الإبداع في بلادي يكون ذلك الشريط ، كنت فقط أريد أن أسمع شيئاً
يخفف عني ذلك الضغط المحتـقن داخل عقلي وصدري ، فجاءني صوته هادئاً ، ولكن
بنبراته القوية الواضحة المعالم وتصحبه موسيقي في هدوء شاعري متميز وجاذب:
مالو .. أعياه النضال .. بدني…
روحي ليه.. ليه مشتهية ودمدني
كنت أزور أبويا .. ودمدني..
وأشكي ليهو …الحضري والمدني
فقلت ياسبحان الله ، ما أجمل هذا الصباح الأبيض ، وسرعان ما بدأ الهم والغم
يتسرب من صدري وينسحب بعيداّ بعد أن جثم عليه بكل عنف يوماً كاملاً ،
فإنزاحت سحابة الغم الداكنة من خيالي وسافرت مرتفعة في الفضاء الرحيب بعد
أن جاءني صوته.. صوت أبو الأمين كي يشدني مع جماليات خليل فرح إلي جماليات
ودمدني .. عشقي المستديم.. ودمدني التي كانت ولا تزال تعانق النجوم ..
وتتغطي بالنجوم ، فنحن أيضاَ ظللنا في إغترابنا نعلق أنجمنا ، فإنتشيت
وحلقتُ في أجواء عالية ( إلي حيث لا حيث ) ، فطافت بخيالي ودمدني وذكريات
أزمنة كانت أنيقة وخبايا أمكنة كانت رقيقة في تلك المدينة الوطن ، ليمتليء
كياني ويزدحم بالنشوي ، فتسمرت ولم أحرك السيارة من جراج المنزل إلا بعد إن
إنتهت تلك الأغنية الخالدة التي قام أبو الأمين ببعثها من جديد بعد أن كانت
قابعة في سجلات التاريخ منذ أن كتبها الراحل المبدع ( خليل فرح) في عام
1930م وهو في طريقه بالقطار من الخرطوم صوب ودمدني للمشاركة في فرح فنان
السودان الأول ( الحاج محمد أحمد سرور) إبن قرية ودالمجذوب شمال ودمدني ،
فشدتني الأغنية تماماً نحو عُشقي .. نحو مدينة الأحلام .. ودمدني… ورحم
الله خليل فرح ، ورحم الله سرور.
ولأجل ذلك، وبسبب كل ذلك .. وبسبب تلك الحزمة من الوجد والعشق لودمدني
الروح
كانت رائحة الرواية ( الذكريات ) تستفزني أن أكتبها .. فكانت ودمدني هي تلك
الرائحة، ولأجلها جاءت فكرة الإصدارة القادمة .. جاءت لتحكي ودمدني قصتها
بنفسها .. تحكي بعضُُ منها لأهل السودان عامة ولأهل ودمدني في كل مكان. .
وختاماً نقول … معاً قريباً إلي ودمدني ( المذكرات) ومعها كل ضواحيها التي
تحاصر وتجمِّـل خاصرتها .. وإلي ناسها وإلي أحيائها بكل حواريها وأزقتها..
إلي همومها وإهتمامات أهلها المتعددة المتألقة في ذلك الزمن البعيد القريب
خلال فترة الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين.. وإلي مفاصل
حياتها الإجتماعية والأدبية والفنية والسياسية وعمالقة الرياضة فيها منذ
زمن بعيد ، وإلي حلقات الذكر والقباب التي تحرسها برعاية الله من كل
الشرور.. وإلي حكاوي أسواقها الرشيقة .. وشخصياتها الجادة والمرحة أيضاً
والتي كانت تعيش في ذلك الزمان .. مع كل ذلك الزخم ذو الطعم اللذيذ القادم
من داخل نسيج مجتمع ودمدني .. نواصل الحكاوي .. عن مدينة الأحلام تلك ..
قريباً جداً في كتاب قادم من بين تزاحم ذكريات ذلك الزمان الجميل ( عقد
الستينيات) .. ليطلع عليه أبناء المدينة داخل الوطن ، وفي كل شتات مهاجرهم
في كل الدنيا.. وأيضا إهداءة لأهل السودان من الذين لم يحالفهم الحظ في
رؤية مدينة الأحلام .. ودمدني ... إنشاء الله ،،،،
|